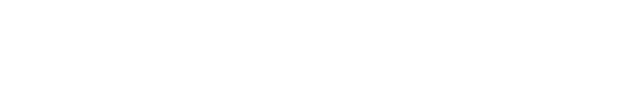المواجهة اللاّتكافؤية واللاّتناظرية، والمستمرّة بشكل دوريّ بين دولة إسرائيل وقوى المقاومة الفلسطينية في غزة، لا تعكس فقط سياسات القوى الحاكمة اليوم داخل المجتمعَين. وليست ثمرة لسياستَي حكومة نتنياهو اليمينية الاستيطانية وحركة حماس فقط. لا شكّ أن هذه القوى هي التي تتحمّل المسؤولية المباشرة عن قرارات تتّخذها كما عن نتائج تلك القرارات، وذلك بحُكم كونها قوى ذات قدرة عسكرية، وإن كانت قدرة غير متساوية ولا متكافئة.
ولكنّ نظرة على تاريخ العلاقات بين إسرائيل وغزة كفيلة بأن تبيّن لنا أن الأمر يتعلق بمواجهة مستمرّة وثابتة، هي أبعد من نهج هذا القائد السياسيّ أو ذاك ممّن يحكمون في إسرائيل، وأبعد من هذا الحزب الصهيوني الحاكم أو ذاك، كما هي أبعد من مسألة أيّ من قوى المقاومة الفلسطينية تسيطر في المرحلة التاريخية في قطاع غزة. المواجهة المستمرّة هي في الأساس استمرار نزف جُرح بليغ من جراح نكبة 1948 لم يُشفَ بعد. إنها مواجهة بين دولة صهيونية قامت على النهب والاقتلاع وبين مقاومة المقتلَعين، مقاومة ضحايا انشائها الرئيسيين.
منذ 1948 أصبحت غزة مجمّعَ التركيز الأكبر والأكثر كثافة للاّجئين الفلسطينيين في المنطقة. فوق قطاع ضيّق من الأرض جرى تركيز عدد من اللاّجئين فاق ضِعف عدد السكان الذي كان في القطاع نفسه من قبل. من جميع بلدات الساحل الفلسطيني، من يافا وضواحيها، من أسدود، من المجدل، وأيضًا من نواحي النقب الغربي، أُزيحَ الفلسطينيون ودُفع بهم إلى قطاع غزة. ليس فقط في أثناء معارك واحتلالات 1948، وإنّما أيضًا في 1950، وحتى في 1951، طُرد جزء من سكان المجدل وجرى توطين لاجئين يهود فيها، كانوا قد وصلوا لتوّهم؛ كما جرى تحويل اسمها إلى "أشكِلون". لاحقًا، أيضًا، في سنوات الـ50 استمرّ طرد عرب بدو من أنحاء النقب. في الواقع طُرد معظمهم إلى سيناء والأردن، ولكن عددًا غير قليل منهم أُرسِل على يد الجيش الإسرائيلي إلى غزة أيضًا. لقد كان الترانسفير كارثة على المقتلَعين من أرضهم. وقد تحوّلت الكارثة إلى واقع دائم، عندما انتهجت إسرائيل سياسة منع العودة، حتى بواسطة القتل بالرصاص لمن أسمتهم "متسلّلون" بسبب محاولتهم العودة إلى أراضيهم. ومنذ تلك الفترة عاش اللاّجئون في كثافة سكانية وفقر تحت قيود عسكرية وسياسية – قيود مدمَجة، وجب القول، فرضها الجانبان الإسرائيلي والمصري. منذ العام 1948 كان سكان قطاع غزة – اللاّجئون الجدد، وأيضًا جزء كبير من السكان المحليين (الذين تغيّر واقع حياتهم تمامًا في أعقاب النكبة)، في مواجهة دولة قرّرت الإغلاق عليهم ومنع عودتهم.
في عام 1956 أحسن موشيه ديان التعبيرعن هذه المواجهة، وذلك في تأبينه الشهير لعسكري إسرائيلي يُدعى روعي روتبرغ، كان مسؤول الأمن في كيبوتس ناحل عوز، قُتل في أثناء تسلّل فدائيين فلسطينيين من غزة كانوا قد اخترقوا الشريط الحدودي الذي شكّل الكيبوتس حماية له. من الجدير قراءة أقوال ديّان، الذي كان حينها قائد أركان جيش إسرائيل، بتمعّن. ففي أقواله تجدون المفتاح لفهم أسُس السياسة الإسرائيلية تجاه غزة منذ ذلك الوقت وحتى بداية السبعينيات، حيث بدأت محاولة الاستيطان في القطاع؛ وتلك سياسة جرى انتهاجها مجدّدًا في بداية التسعينيات، وانتُهجت بشكل أكثر تشدّدًا في أعقاب إخلاء المستوطنات، عام 2005، وفرض الحصار المستمرّ حتى اليوم. منذ بداية السبعينيات (سنوات الامبراطورية الإسرائيلية السّكرى بنشوة إنجازاتها العسكرية في 1967) وحتى بداية التسعينيات (سنوات تمأسُس سياسة الإغلاق والجدران)، استمرّت طيلة أكثر من 20 سنة محاولة تحويل اللاّجئين في غزة إلى قوّة عمل رخيصة في مرافق الاقتصاد الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه الاستيطان في الأراضي الزراعية داخل قطاع غزة. منذ نهاية الانتفاضة الأولى بدأ انسحاب تدريجيّ من تلك التجربة، وهو انسحاب كانت إشارتاه المركزيّتان التسييج التامّ حول القطاع (في 1996) وتفكيك المستوطنات في فك الارتباط أحاديّ الجانب (في 2005). بذلك عادت إسرائيل إلى سياستها القديمة، سياسة إغلاق بوّابات غزة على اللاّجئين وذريّتهم.
هذا هو المنطق العميق والجذري الكامن وراء الحصار المفروض على غزة. وأنا لا أقلّل بهذا من أهمية المواجهة مع حركة حماس، أو من الطموح إلى إسقاط السلطة الفلسطينية، أو تكريس الانقسام بين الفلسطينيين في الضفة والفلسطينيين في قطاع غزة وبينهم جميعا (أي فلسطينيو الضفة والقطاع) وبين أولئك الذين في إسرائيل كاعتبارات مهمّة في السياسة الإسرائيلية. ولكن هذه وسائل ثانوية نسبة إلى الهدف المركزي، نسبة إلى المنطق العميق لتلك السياسة: حرب دائمة ضدّ الشعب الفلسطيني، وفي الأساس – توجيه الضربة تلو الضربة إلى اللاّجئين الفلسطينيين، بغرض منع عودتهم وبالتالي منع زعزعة الواقع الذي نشأ في 1948.
أقترح قراءة متمعّنة في تأبين ديّان، المذكور أعلاه، من عام 1956، إذ قال:
"أمس مع الصباح قُتل روعي. لقد بهرَه هدوء صُبح الربيع فلم يرَ أولئك الذين كمنوا لروحه على الشريط الحدودي. دعونا اليوم لا نلقي التّهم على القتَلة. إذ ماذا يمكننا قوله عن كراهيتهم الشديدة لنا؟ منذ ثماني سنوات وهم يقبعون في مخيّمات اللاّجئين في غزة، وأمام أعينهم نحن آخذون في تملّك الأرض والقرى التي عاشوا فيها هم وآباؤهم.
ليس من العرب سنثأر لدماء روعي، وإنما من أنفسنا. كيف أغمَضنا أعيننا عن النظر مباشرة إلى مصيرنا، وعن رؤية قدر جيلنا بكلّ ما فيه من قسوة؟ هل نسينا أن ثلّة الشبيبة هذه، التي تجلس في ناحل عوز، تحمل على أكتافها بوّابات غزّة الثقيلة؟ بوّابات تصطفّ خلْفها مئات آلاف الأعيُن والأيدي تصلّي ليوم نضعف فيه، لكي تستطيع تمزيقنا إرَبًا – أنسينا ذلك؟ نعم نحن نعرف، أنه لكي يذوي الأمل في إفنائنا علينا أن نكون، صُبحًا ومساء، مسلّحين ومستعدّين.
نحن جيل الاستيطان، وبدون خوذة الفولاذ وفوهة المدفع لن نستطيع غرْسَ شجرة وبناء بيت. لن تكون لأبنائنا حياة إذا لم نحفر الملاجئ، وبدون أسلاك شائكة وبندقيّة لن نستطيع شقّ طريق ولا استخراج الماء. ملايين اليهود، الذين أبيدوا ولا وطن لهم، ينظرون إلينا من رماد التاريخ الإسرائيلي ويوصوننا بالاستيطان وبالبدء في إقامة وطن لشعبنا. ولكن، من وراء شريط الحدود يموج بحر من الكراهية والرغبة في الانتقام، يرنو إلى يوم تُضعف فيه الطمأنينة انتباهَنا، إلى يوم نصغي فيه إلى سفراء النفاق المحتال، الذين يناشدوننا إلقاءَ سلاحِنا. صراخ دماء روعي يعلو إلينا من جسده الممزّق. ومع أننا أقسمنا ألفًا أنّ دماءَنا لن تُساحَ هدرًا – وقعنا أمس في الإغراء مرّة أخرى، استمعنا وصدّقنا. اليوم سوف نحاسب أنفسنا. لن نرتدع عن النظر إلى العدائية التي ترافق وتملأ حياة مئات آلاف العرب، الذين يعيشون حولنا ويرنون إلى لحظة تتمكن أيديهم من ذبحنا. لن نشيح بأعيننا فتكلّ أيدينا. إنه قدر جيلنا. إنه خيارُنا في الحياة – أن نكون مستعدّين مسلّحين أقوياء وقُساة وإلاّ فسوف يسقط السيف من يدنا – وتُجدع حياتنا.
روعي روتبرغ، الشاب الأشقر النحيل، الذي ذهب من تل أبيب لكي يبني بيته على أبواب غزّة، لكي يكون لنا سُورًا. روعي – النور في قلبه قد عمى عينيه، فلم يرَ التماعة السيف. التوق إلى السلام صمّ أذنيه، فلم يسمع نداء القتل يتربّص به. لقد ثقلت أبواب غزّة على كتفيه فغلبته".
لقد أثّر هذا الرثاء في تشكيل الفهم الأمني-الاستيطاني، الذي صاغه الجيل الأول من القادة والمحاربين الصهاينة بعد النكبة وتأسيس إسرائيل كدولة. هناك أمران يبرزان في هذا الخطاب عندما نقرأه من وجهة نظر حالية:
الأمر الأول هو غياب التقية والكذب التاريخي الشائعين اليوم في الخطاب الصهيوني. مخْلصًا للحقيقة تحدّث ديّان عن كراهية لها ما يبرّرها لدى اللاّجئين الفلسطينيين في غزة تجاه إسرائيل: "ما الذي سنقوله عن كراهيتهم الشديدة لنا؟ منذ ثماني سنوات هم يقبعون في مخيَمات اللاّجئين التي في غزة، وأمام أعينهم نحن آخذون في تملّك الأرض والقرى التي عاشوا فيها هم وآباؤهم". على عكس القادة الصهاينة في أيامنا، لم يُنكر ديّان النكبة، لم يزيّف ولم يكذب. لم يحاول التمويه في هذا التأبين، ولا التنكّر لمسؤولية دولته وأبناء جيله. إنه يقول بصريح العبارة: الأراضي كانت لهم، أخذناها، طردناهم وتملّكناها – فكيف لا يكرهوننا؟ كيف لا يحاولون العودة والكفاح لأجل ما هو لهم؟ لم ينسب ديّان للفلسطينيين، في أقواله تلك، أيًّا من صفات التحمّس للقتل والتعصّب واللاّعقلانية. المقاومة القتالية من طرفهم كانت مفهومة في نظره، بلْ كانت مبرّرة ومستدعاة أيضًا إذا ما نظرنا إلى الصراع من وجهة نظرهِم هُم. في ربيع 1956 لم يجد ديّان أيّة صعوبة في تخيّل كيف تبدو الأمور من وجهة نظر فلسطينية.
الأمر الثاني الذي يبرز في الخطاب/الرثاء، هو غياب أيّ استعداد لإصلاح الغُبن، أو للبحث عن تسوية أيًّا كانت، كما الإعلان الفظّ – الصارخ الوضوح – عن حرب دائمة ضدّ الفلسطينيين انطلاقًا من رؤية وجودية مفادها: "إمّا نحن، أو هُم". بالضبط كما نتنياهو وليبرمان وبنِت اليوم، لم يبحث ديّان هنا عن تسويات وحلول وسط، ولا عن إصلاح ومصالحة. لم يكن مسعاه تقديس الحياة المستقبلية للشعبين، وإنما رأى علاقتهما حربًا دائمة يستحيل منعُها. ربّما يمكن اعتبار ليبرمان الصوت الحاليّ الأكثر شبهًا بصوت ديان آنذاك؛ بلا تفلسف وبدون اعتبارات أخلاقية: تصوّر الحياة كحرب وجود ينتصر فيها الأعنف والأقوى ولا مكان فيها لشعبين وإنما لأحدهما فقط.
المسألة هي أن ديّان الـ1956 تحدّث وفكّر بمصطلحات ما أسماه "جيل الاستيطان"؛ ولكن أفعال ذلك الجيل أنشأت واقعًا يعيد إنتاج نفسه منذ ذلك الوقت وحتى اليوم. كان ذلك أوّلاً وقبل كلّ شيء بمجرّد الاحتلال العسكري وتوسيع مساحات التسلّط والاستيطان الصهيوني في أعقاب حرب 1967، وهي عمليات كان لديّان دور مركزيّ فيها. ثم بتصوّر المواطنين اليهود، سواء مهاجرين أو مواليد البلاد، كمستوطنين يؤدّون دور "جدار حيّ" أو "قود فوهات مدافع" للوقوف في وجه الفلسطينيين المقتلعين ومنع عودتهم إلى الأراضي وبالتالي التسبّب لهم في التسليم بالهزيمة.
وهكذا فإن وصف ديّان حياة جيل الاستيطان كمعركة وجود قاسية، تحوّل إلى واقع دائم في حياة الأجيال اللاّحقة. اللاّجئون الفلسطينيون في غزّة، في 2009، في 2010، في 2013، وفي 2014 هم الجيل الثالث والرابع للاقتلاع، اللجوء، الاحتلال والدّمار. والجنود الإسرائيليون الذين يسقطون على أبواب غزّة وفي داخلها، هم في جزئهم الأكبر الجيل الثالث والرابع للاستيطان، جيل "خوذة الفولاذ وفوهة المدفع" والأسلاك الشائكة. كذلك فأبناء الكيبوتس، الذين سقطوا تحت قذائف الهاوْن في دورة الحرب الأخيرة، هم المقابل المعاصر لروعي روتبرغ: "جدار حيّ" و"قود مدافع" لأجل إدامة الاقتلاع.
إنّ شعبَينا محصوران داخل فخّ العنف والمعاناة التي ولّدها المنطق الاستيطاني الصهيوني. إن انعدام الاستعداد لإصلاح الغُبن الناجم عن جرائم الماضي يحوّل الحياة هنا إلى سلسلة من دورات العنف المباشر أو غير المباشر، دورات من القمع والانتفاضات. إن إدامة جرائم أوّل أمس ولّدت جرائم أمس وأدّت إلى جرائم جديدة، وهي تولّد المزيد والمزيد من الجرائم المروّعة. من المفهوم أنّ شعبَينا محصوران في فخّ الصراع العنيف ليس بالقدر نفسه ولا بالشدّة نفسها أو بالمستوى نفسه من المعاناة، وبالتأكيد ليس على نحو تناظريّ. ذلك لأنّه مع ذلك هناك "شعب محتلّ" و"شعب واقع تحت الاحتلال"، أو "شعب مستعمِر" و"شعب مستعمَر"؛ هناك من هُم أصحاب امتيازات في الحقوق ومن هُم فاقدون للحقوق والفرص؛ هناك من يعاني أكثر في حياته اليومية ومن يعاني أقلّ؛ وهناك علاقات قوّة وعنصرية ممأسسة حيث موت العشرات في الجانب الإسرائيلي يُردّ عليه فورًا بموت مئات وحتى آلاف الفلسطينيين. ومع ذلك، وأيضًا من أجل النضال الفلسطيني العادل، لأجل فُرص الفلسطينيين في الانتصار على الصهيونية واستعادة الحقوق والأراضي وبناء المستقبل، من المهم أن نفهم ما يلي: في داخل الشعب المستعمِر أيضًا، بين اليهود، هناك فروق وفجوات كبيرة. هناك غُبن وظلم وهناك استعمار وضحايا استعمار. يهود الدول العربية والإسلامية هم أيضًا نوعًا ما ضحايا الاستعمار الاستيطاني. لقد نجحت الصهيونية في توظيفهم لاحتياجاتها، ولكنها تظلمهم وتضرّ بهم بشكل عنصري من خلال اقتلاعهم من ثقافتهم، وتحويلهم إلى ذوي مكانة دونيّة في المجتمع الإسرائيلي، والمسّ بانتمائهم للمنطقة. إنّ وضع يهود الشرق – وجزء منهم عرب-يهود في الأصل – في مواجهة الفلسطينيين وكلّ العرب هو أحد النجاحات الاستراتيجية المهمّة للصهيونية. وهذا هو أحد مصادر ضعف المقاومة العربية.
منذ خطاب ديّان تحوّلت الصهيونية أيضًا إلى رأسمالية أكثر فأكثر، وإلى القسوة أكثر فأكثر تجاه جزء من يهودها. هؤلاء جيّدون بما يكفي ليكونوا جنودًا في الحروب ومستوطنين فوق الأراضي الفلسطينية، ولكنهم ليسوا جيّدين بما يكفي ليكونوا شركاء النخب الثريّة في اقتسام الغنائم والأرباح. هل أولئك اليهود الذين جرّبوا العنصرية والقمع والاستغلال الطبقي يمكنهم التحرّر من الأيديولوجية الصهيونية ومدّ اليد لشراكة حقيقية مع الفلسطينيين ضدّ من يحكمونهم ويسيئون استخدامهم؟ من الصعب معرفة الجواب، وعمومًا من الصعب جدًا أن نصدّق أن ذلك ممكن. قد يتحرّر جزء منهم، قد تتحرّر فقط قلّة منهم، ولكن كلّ واحدة وواحد منهم يخطو خطوة كهذه، نحو الخروج من المعسكر الصهيوني، نحو مقاومة استخدامهم كـ"قود مدافع" وكـ"جدار حيّ" هو في الوقت نفسه جندي واحد أقلّ في خدمة الصهيونية، هو قوّة تحريرية، وهو حليف محتمَل، للنضال الفلسطيني.
إذن، في الواقع نحن لسنا نقول "ملَلنا من بيبـي نتنياهو ومن حماس" – كما كان قد هتف بعض اليساريين الصادقين وأصحاب النوايا الحسنة في ساحات تل أبيب أثناء الاحتجاجات ضد دورة الحرب الأخيرة في الصيف. لم نملّ نتنياهو، لأن نتنياهو ليس هو المشكلة. وحركة حماس أيضًا وبالتأكيد ليست هي المشكلة. كما أنه لا تكافؤ ولا تناظُر بين هذين الطرفين. الصهيونية هي أصل المشكلة. نحن مللنا من فخّ الاستيطان، فوهة المدفع، خوذة الفولاذ، وقبّة الحديد. ملَلنا من الأسلاك الشائكة، ومَللنا من الحرب الدائمة لأهداف تثبيت جرائم وغنائم النكبة وتوسيع دائرة النّهْب والاقتلاع. لقد ضقنا ذرعًا بنهج الصهيونية الكولونيالي المتسيّد وبالعنف المرافق له.
عندما نتناول موضوعة الحرب والعنف، علينا أن نتفحّص مصادر العنف، التي أشار إليها موشيه ديّان في حينه – ليس فقط عنف البندقية والمدفع، وإنما العنف المرافق لعملية الاستيطان والنهب والطرد ومنع العودة، والعنف الناجم عن تلك العملية. كذلك علينا أن نواجه مصادر العنف تلك لكي نتحرّر من لعنة الحرب التي تخيّم فوقنا.
حقّ العودة، والعودة نفسُها، ومواجهة غُبن الماضي لأجل ترتيبات المستقبل، هي شرط حيوي لأي تغيير حقيقيّ هنا. في هذا الواقع، واقع العنف الدوريّ، ينبغي أن يكون مطلب حق العودة والنضال لأجل العودة في موقع أكثر مركزيّة لدى مَن يريدون تخليص شعبَينا من فخّ الصهيونية الكولونيالية. هذا يعني أن نتحدّث عن ذلك. وهذا يعني أن نناضل لأجل ذلك، من منطلق الإدراك أن المسألة تتعلق بتغيير حقيقي في الواقع الراهن اليوم في إسرائيل، وتتعلق بعودة الناس، وبتسويات أراض جديدة من نوعها، كما تتعلق بالتنازل عن امتيازات في الحقوق يحوزها كثيرون جدًا من الإسرائيليين (بما في ذلك امتيازات يتمتّع بها كاتب هذه السطور) وذلك لكي تكون الحقوق للجميع، لكي يتمّ إصلاح الغُبن. هذا هو واجبنا كناشطين في داخل إسرائيل – يهودًا وعربًا سواءً بسواء. إنه بالتأكيد واجب أخلاقي تجاه الذين مُنعت عنهم العودة، وإنه أيضًا واجب عمليّ وبراغماتي لأجل توفير الأمن لأبنائنا نحن.