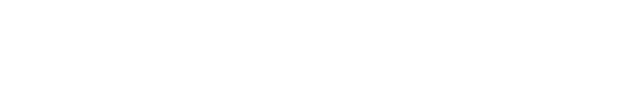نصار إبراهيم - كاتب وباحث فلسطيني, مركز المعلومات البديلة
يثير إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول القادم لنيل الاعتراف بعضوية الدولة الفلسطينية في الهيئات الدولية حالة من الجدل والسجالات السياسية والقانونية في الساحة الفلسطينية والدولية، وبقدر ما كانت تجري مقاربة هذا الحدث، سواء من قبل الهيئات الوطنية أو التنظيمات السياسية أو مؤسسات المجتمع الفلسطيني، بقدر ما كانت تتوالد الأسئلة المتعلقة بهذا الاستحقاق وتزداد تعقيدا وتشابكا، الأمر الذي يشير إلى افتقاد تلك الخطوة للنواظم والإستراتيجية السياسية الوطنية التي يجب أن تحكم حركة وخط سير مثل هكذا خيار.
مقاربة هذا الخيار بمستوياته وأبعاده المختلفة تستدعي بالضرورة تحديد المرجعية ونقاط الانطلاق التي يجب أن تحكم هذه العملية كي لا يسقط النقاش في مصيدة السجال والاستخدام السياسي التكتيكي. من هنا تبرز القيمة السياسية والعملية الكبرى بضرورة التعامل مع هذا الاستحقاق في إطار سياقاته التاريخية السياسية, التي لا يجوز فصلها عن سياقات النضال الوطني الفلسطيني المرتبطة بأهدافه الكبرى, التي تعود دائما إلى جوهر ومحددات الصراع مابين المشروع الكولونيالي الصهيوني بكل أهدافه وتجلياته والمشروع الوطني التحرري الفلسطيني. من هنا يجب أن يبدأ النقاش، بمعنى أنه لا يجوز التعامل مع استحقاق أيلول كمناورة دبلوماسية محكومة بسقف إستراتيجية ما يسمى بعملية السلام (المفاوضات), التي بدأت مختلة في الجوهر منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 وصولا إلى انغلاق أفق هذه العملية بسبب افتقادها لشروط وعوامل النجاح الأساسية منذ اللحظة الأولى، وذلك بسبب بنائها على مرجعية وشروط القوة كما يراها الحلف الإسرائيلي-الأمريكي المدعوم من الاتحاد الأوروبي والنظام الرسمي العربي المرتبط بهذا الحلف.
إذن، التعامل مع استحقاق أيلول يجب أن يخرج من مستوى الفهم الضيق (مع أو ضد) ليرتقي إلى مستوى المقاربات الإستراتيجية، بمعنى ضرورة تحديد الأسس والنواظم الإستراتيجية الوطنية, التي على أساسها سيتم التوجه أو عدم التوجه إلى الأمم المتحدة، والنقاش هنا يتخطى السجالات القانونية وحملات العلاقات العامة أو توظيف الخطوة لمناكفة الطرف الآخر، ما يثير القلق أن هذا الاستحقاق تم طرحه بصورة ارتجالية ولم يأت كتتويج لعملية تقييم للأداء السياسي الفلسطيني منذ أوسلو وحتى اليوم. وبكلمات أخرى إنه خيار أزمة أو فشل أكثر منه خيار يعبرعن إستراتيجية وطنية جديدة.
المشكلة ليست في الذهاب إلى الأمم المتحدة من حيث المبدأ; المشكلة هي في أية سياقات يأتي هذا التوجه، فهل تعني هذه الخطوة فك الارتباط مع استراتيجيات ومرجعيات التفاوض السابقة (شروط القوة) والعودة إلى مقررات الأمم المتحدة والشرعية الدولية كمرجعية لأي عملية سلام في المستقبل، والتعامل معها كحلقة في سلسلة إعادة بناء النضال الفلسطيني بما في ذلك متطلبات الوحدة الوطنية وإعادة الاعتبار للمقاومة بكل أشكالها واستحقاقاتها، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وفق برنامج سياسي وطني جامع يقوم على التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة (حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وتفكيك المستوطنات).
الشعب الفلسطيني بمعظمه غير معني بالسجالات القانونية والمناورات السياسية. ما يهم الشعب الفلسطيني هو الإجابة على سؤال بديهي وبسيط: هل هذه الخطوة ستعزز الحفاظ على قضيته وحقوقه ووحدته الوطنية ونضاله وتضحياته أم لا؟ هنا تتحدد مرجعية النقاش وليس أي شيء آخر. بهذا المعنى يصبح التوجه إلى الأمم المتحدة جزء من إستراتيجية وطنية وليس هو الإستراتيجية بحد ذاتها، فالذهاب إلى الأمم المتحدة في أيلول القادم ليس نهاية المطاف ولا يجب أن يكون كذلك، لأن المؤشرات والحقائق تقول بأن الواقع لن يتغير كثيرا.
تجربة النضال الوطني الفلسطيني على مدار العقود الماضية تؤكد أن الحفاظ على الانسجام مابين متطلبات الحقوق الوطنية الفلسطينية كثابت والحركة السياسية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني وقواه ومؤسساته السياسية هو الذي كان يحفظ دائما خط السير من مخاطر الانحراف ويضبطه في سياق استراتيجي يعظم عوامل القوة الفلسطينية ويحد من عوامل القصور، وفي كل مرحلة كان يجري فيها انتهاك هذا الناظم لأهداف تكتيكية أو استخدامية كانت الأثمان التي يدفعها الشعب الفلسطيني من حقوقه وتضحياته هائلة. هذا ما تبرهنه تجربة اتفاقات أوسلو بسنواتها الممتدة، تلك التجربة المرة بسنواتها وحصادها، والسبب يعود إلى كون عملية السلام المذكورة لم تحافظ على أسس وأهداف وشروط مرحلة التحرر الوطني، حيث توهم البعض أن مجرد بدء المفاوضات وقيام السلطة الفلسطينية يعني أن الشعب الفلسطيني قد تخطى مرحلة التحرر الوطني بكل محدداتها السياسية والتنظيمية وما يرتبط بها من أشكال نضال تستجيب لطبيعة الصراع وطبيعة المشروع الصهيوني الكولونيالي العنصري المتحالف عضويا مع الكولونيالية العالمية.
وفي كل الأحوال على القيادة السياسية الفلسطينية أن تتذكر أن فشل جميع ما يسمى مبادرات السلام السابقة يعود إلى كونها كانت تقفز عن ثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية ووحدة مصير الشعب الفلسطيني وتقديم التنازلات التي مست في العمق أسس تلك الحقوق مما أفقد تلك المبادرات السياسية ومنذ البداية شرعيتها الوطنية بحيث باتت في عيون معظم الشعب الفلسطيني مجرد خيارات سياسية وطبقية ضيقة, تتناقض مع مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الكبرى، فيما الطرف الآخر بقي متمرسا عند ثوابته وما يدعيه من حقوق في استعمار فلسطين بما في ذلك الحق في استيطان أي جزء منها.
ما تقدم ليس سجالا مفتعلا، كما أنه ليس إسقاطا ذاتيا، بل هو في الجوهر عودة إلى الأصول التي تاهت في مراوغات السياسة التي لم تزل تواصل الرهان والتكيف مع اشتراطات النقيض باسم الواقعية أحيانا وباسم الظروف الموضوعية وموازين القوى في أحيان أخرى.
انطلاقا من ذلك فإن أي خطوة سياسية أو خيار سياسي فلسطيني يجب أن يستند إلى محددات وشروط ومتطلبات مرحلة التحرر الوطني بأهدافها واستراتيجياتها المتنوعة التي تستمد شرعيتها وأخلاقيتها من التزامها وتمسكها بالحقوق الوطنية الفلسطينية وعدالة النضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير. هذا هو الثابت الذي يحدد حركة ما عداه.
في ضوء هذه الحقيقة والمعطى العملي للتجارب السابقة فإن التحدي الأبرز الذي يواجه القوى السياسية والنخب الاجتماعية والثقافية الفلسطينية تجاه استحقاق أيلول هو في قدرتها على الخروج من متاهة العقدين المنصرمين والارتقاء بالموقف والأداء السياسي والاجتماعي والثقافي إلى مستوى متطلبات النضال الوطني الفلسطيني وثوابت القضية الفلسطينية وعدم الهبوط به إلى مجرد مناظرات قانونية ودبلوماسية.
تحقق هذه المعادلة الوطنية ارتباطا باستحقاق أيلول مرهون بضرورة تأمين شرطين أساسيين؛ الأول: إعادة ترميم الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية بحيث تستعيد التوازن وفق الأولويات الوطنية على كل المستويات، انطلاقا من كون الشعب الفلسطيني لا يزال يعيش في إطار مرحلة التحرر الوطني بكل اشتراطاتها وأولوياتها، بما في ذلك التفاعل بين أشكال النضال المختلفة وعدم المساس بثوابت النضال الوطني وقواسمه المشتركة التي تستهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية كشرط لازم لمرحلة التحرر الوطني.
وفي سياق هذا الشرط/الثابت تأتي مهمة المراجعة السياسية لتجربة العقدين الأخيرين لتحديد مظاهر الاختلال والقطع مع الرهانات الخاطئة واستعادة المبادرة وفق المصلحة الوطنية العليا، خاصة بعد الاختبار المتعب والمرهق وطويل المدى المرتبط بعملية السلام وفق الشروط والأولويات الأمريكية–الإسرائيلية، التي لم تسفر سوى عن العبث بثوابت وأولويات ومصالح الشعب الفلسطيني، وهو بالضبط ما حذرنا منه الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش بكلمات جميلة ولكن جارحة:
"لم تفهم (أي إسرائيل) من التسوية غير ما يوفر لها القدرة على أن تنجز، في مناخ السلام الكاذب، ما لم تنجزه في مناخ الحرب، من هيمنة إقليمية، ومن راحة استفراد بالشعب الفلسطيني المحاصر... أما الفلسطينيون فقد استنفذوا كل رصيدهم في المرونة حول نفسها، ودفعوا ثمنا أعلى مما تستحقه تسوية لا تتجاوز الاعتراف بحقنا في إقامة دولة مستقلة على عشرين بالمائة من أرض وطننا التاريخي، دون أن يبدي الجانب الإسرائيلي أي استعداد للانسحاب من متر واحد من مساحة أسطورته عن ذاته وعن التاريخ، التي تعتبر وجودنا التاريخي في بلادنا وجودا احتلاليا غريبا على "أرض اليهود الأزلية-الأبدية"، الخالية منا ومن التاريخ معا" (جريدة الدستور الأردنية، 2002).
أما الشرط الآخر فيتمثل بإعادة بناء الأطر السياسية الفلسطينية (م. ت. ف، والسلطة الفلسطينية) وفق الإستراتيجية الوطنية الجديدة وتحديد التخوم بين مهام الثورة والسلطة، خاصة في ضوء النتائج السياسية والثقافية المروعة التي ترتبت على عملية الخلط بينهما. وإرساء العمل الوطني على أسس ديمقراطية لضمان مشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية وفق أدوارها وأوزانها في الواقع الفلسطيني. والحفاظ على التوازن بين مهام التحرر الوطني ومهام البناء الاجتماعي والتنموي بحيث يكون الأخير متناغما مع البعد الأول وأن لا يشكل قيدا أو إثقالا عليه، هذا يعني العمل للخروج من مصيدة الارتباط بالتمويل الأجنبي الذي تحول إلى وسيلة للضغط والابتزاز السياسي. يضاف لذلك الاستفادة القصوى من الثورات العربية وتوظيفها بصورة حيوية بما يؤمن العمق القومي للنضال الفلسطيني الذي تعرض للتآكل في مرحلة الهبوط العربي.
تأسيسا على ما تقدم يجب أن تتحدد أيضا الفواصل والتخوم بين وظيفة الثورة ووظيفة السلطة انطلاقا من ثوابت التحرر الوطني، حيث أدى الفشل في التعامل مع هذه المعادلة المحورية إلى دفع أكبر حركتين سياسيتين في التاريخ الفلسطيني الراهن (حركة فتح وحركة حماس) نحو الأزمة، حيث قامت السلطة وبصورة ما بإغراق حركة فتح ولاحقا حركة حماس في بناها بحيث بدت الحركتان وكأنهما في خدمة السلطة وليس في خدمة المشروع التحرري كإستراتيجية ناظمة، هذا الواقع أدى إلى تحول جوهري في بنية الحركتين بحيث نجحت السلطة في ربط مصير هاتين الحركتين ودورهما بمصير السلطة، بينما كان المطلوب أن تحافظا على وظيفتهما كقوى تضبط وتوجه أداء السلطة بما يخدم الإستراتيجية السياسية التحررية، دون أن يضرب ذلك بالطبع دور السلطة وأدائها لوظيفتها المدنية والاجتماعية البنائية وتعزيز الممارسة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.
هكذا ببساطة ولد التناقض بين الثورة والسلطة وخرج عن نطاق السيطرة، في حين لو حافظت قوى الثورة على مسافة موضوعية أو مسافة أمان كافية من السلطة، لما وصل الصراع على تلك السلطة المحكومة بالسقف والصلاحيات المنصوص عليهما في اتفاقيات أوسلو وملاحقها إلى حدّ المساس بوحدة الشعب الفلسطيني وتهديد مشروعه الوطني عبر رهانات أظهرت تجربة العشرين عاما الأخيرة مدى عقمها وفشلها كما أظهرت هول تناقضها مع طموحات الشعب الفلسطيني وما قدمه من تضحيات كبرى على دروب حريته واستقلاله.
فشل أو عجز النخب السياسية الفلسطينية في التعامل مع هذه المعادلة أدى إلى حالة الانقسام المتواصلة وحالة الانحباس السياسي والإحباط الاجتماعي العام وبالتالي الأزمة التي يحاول الفلسطينيون عبثا إيجاد الحلول لها من خارج السياقات الفلسطينية، وهو ما جعل من الواقع الفلسطيني واقعا هشا أمام التدخلات الخارجية وبالتالي فقر وهزالة أداء القوى السياسية الفلسطينية في مواجهة التحديات الكبرى التي تطرحها قضية بمستوى وخطورة القضية الفلسطينية.
بالاستناد لهذه المقاربة فإن القيمة الأساسية لاستحقاق أيلول لا تكمن في ما سيحدث، ذلك لأنه سيبقى في كل الأحوال محكوما بسقف علاقات القوة القائمة على أرض الصراع، إن القيمة الأساسية لهذا الاستحقاق تتجلى في كونه يوفر فرصة (في حال أحسن استثمارها) لكي يستعيد الجميع بعضا من توازنهم من خلال العودة للأصول والبديهيات التي يجب أن تحكم الخيارات السياسية الفلسطينية التي يجب أن تبدأ وتعود كلها إلى نقطة الأصل: الحقوق الوطنية الفلسطينية بكل مكوناتها.
- نشرت المقالة في جريدة حق العودة, يوم الاثنين 22/8/2011، العدد 44 , التي يصدرها بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين.